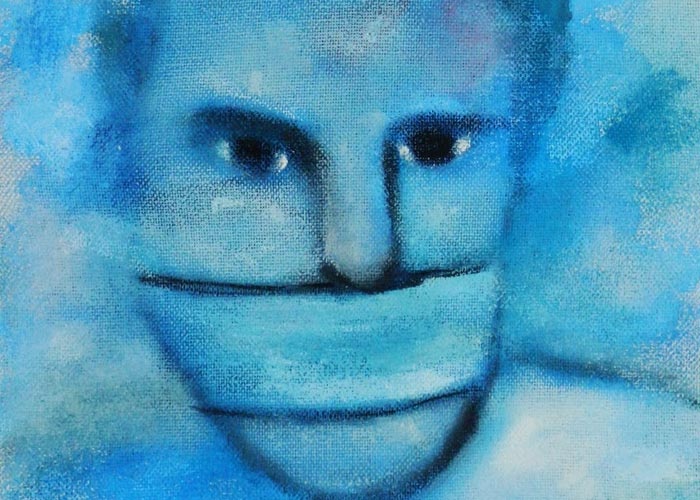
هم الأشخاص الذين ليست لهم القدرة على الكلام بسبب عوامل طبيعية (منذ الولادة) أو عوامل بيئية كحادثة أثرت عليهم مما أدى إلى فقدان الصوت أو عدم القدرة على الكلام.
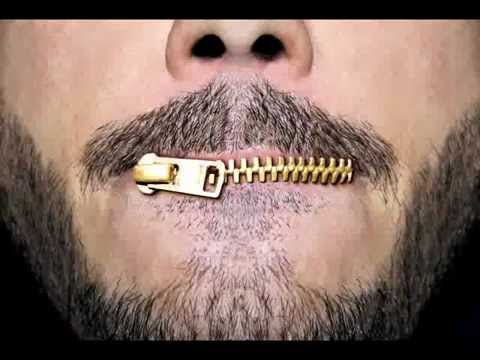
الخَرَسُ: ذهاب الكلام عِيّاً أَو خِلْقَةً، خَرِسَ خَرَساً وهو أَخْرَسُ ، والخَرَسُ ، بالتحريك : المصدر . والكلمة مسموعة في الكويت والعراق وسوريا ولبنان والأردن وفلسطين والحجاز ومصر والسودان، وفي الأحواز: خَرَس.
انظر : " لسان العرب " لابن منظور : خرس ، " قاموس اللهجة العامية في السودان " للدكتور عون الشريف قاسم ص 290 .

أو أعيم ، والأعجم : الأَخْرَسُ. والعَجْماء والمُسْتَعجِمُ: كلُّ بهيمةٍ.
وفي الحديث: " العَجْماءُ جُرْحُها جُبارٌ " أَي لا دِيةَ فيه ولا قَودَ؛ أَراد بالعَجْماء البهيمة، سُمِّيت عَجْماءَ لأَنها لا تَتَكلَّمُ، قال: وكلُّ مَن لا يقدِرُ على الكلام فهو أَعجم ومُسْتَعْجِمٌ. واستعجم الرجل: سكَت .
وقال الشاعر سعد بن عبد الرحمن الغامدي :
وَدَّهْ يوافيني أَيْد الشرع والفِي
وأتْكلَّم ما نِب بأعجم .
والكلمة مسموعة في اليمن وجنوب السعودية وجنوب عمان .
تصغير الْعًجًم، عْجَيْم، مثل تصغير العَوَر عْوَيْر.
ومنه تسمية (العجمان) القبيلة المشهورة المتفرعة من (يام) فهم منسوبون إلى جدهم كان أخرس فسموه وهو صغير (عجيم) ثم لما كبر وصفوه بأنه (عَجَم) أي أعجم لا يستطيع النطق.
وقد اشكل على بعض الباحثين كون الفرسان من قبيلة العجمان يقولون في التمدح بأنفسهم (انا ابن العجم) وهذه صيغتها الظاهرة على لفظ (العجم) الذين هم ضد العرب، والواقع أن الأمر ليس كذلك وإنما مراده أنه ابن الأعجم، يفتخر بنسبته إلى جد العجمان الذي هو (أعْجَم).
ويقال للدواب: عُجمٌ، لأنها لا تتكلم، ويقال للظهر والعصر العجماوان، لأنهما لا يُجهر فيهما بالقراءة.
قال ابن منظور: (الأعْجَمُ): الأخْرَسُ.
انظر: "لسان العرب" لابن منظور:عجم، "معجم الأصول الفصيحة للألفاظ الدارجة" لمحمد بن ناصر العبودي 9\74، "العامي الفصيح في كلام غامد وزهران" لمحمد بن سعيد الغامدي ص563.